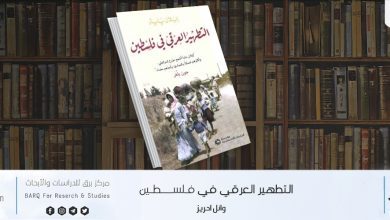خلفيات موقف النظام الجزائري من الأزمة في سوريا

فاجأت تصريحات وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة” التي اعتبر فيها أن النظام السوري استرجع مدينة حلب من الإرهابيين؛ الكثير من المتابعين للسياسة الخارجية الجزائرية، والتي من مبادئها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتفضيل الحلول السياسية والمصالحة الوطنية لحل الأزمات خاصة في الدول العربية.
وقبل الحديث عن الأسباب التي دفعت رمطان لعمامرة للإدلاء بهذا التصريح، الأول من نوعه من حيث الوضوح لمسؤول جزائري بشأن الأزمة السورية، نود الإشارة إلى أن النظام الجزائري لم يسبق له أن اتخذ موقفا صريحاً من ثورات الربيع العربي سواء في تونس أو ليبيا أو مصر أو اليمن كالذي أعلنه لعمامرة حينما وصف المعارضين السوريين المسلحين في حلب بأنهم “إرهابيون”.
وانطلاقا من هذا الأمر يمكن تفسير تصريحات وزير الخارجية الجزائري من الأزمة السورية في النقاط الآتية:
ـ التصريح جاء كرد فعل على مقال ورد في صحيفة بلجيكية، توقع أن تتحول الجزائر إلى سوريا ثانية في شمال إفريقيا، ما أثار غضب الخارجية الجزائرية واستدعى رداً من سفيرها في بلجيكا. وذلك قبل أن يصرح لعمامرة رداً على سؤال طرح عليه على هامش مؤتمر السلم في إفريقيا عقد بمدينة وهران الجزائرية (غرب): “ما حدث في سوريا هو أن الدولة السورية استطاعت استرجاع سيادتها وسيطرتها على مدينة حلب”. مضيفاً: “أن الأشخاص الذين هم وراء تصريح بروكسل، كانوا يحلمون بانتصار الإرهاب في حلب وفي أماكن أخرى، وقد فشل الإرهاب، فهم يظنون أنه يمكن أن ينجح في الجزائر”.
فالمقال البلجيكي الذي توقع أن تشهد الجزائر نفس مصير حلب، بكل ما تحمله الكلمة من حرب أهلية ودمار، أخرج السلطات الجزائرية من تحفظها المعتاد، ودفعها للمجاهرة برؤيتها تجاه الأزمة السورية، بالرغم من دعوات شعبية وخاصة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للسلطات الجزائرية بالخروج من حيادها أمام التهجير القسري لسكان حلب وإقامة جسر إغاثي عاجل.
ـ لطالما نظر النظام الجزائري إلى ثورات الربيع العربي على أنها تهديد مباشر له، خاصة بعد احتجاجات “الزيت والسكر” بالجزائر، في يناير/كانون الثاني 2011، التي أعقبت الثورة التونسية. وتوقع محللون من خارج الجزائر أن تتحول تلك الاحتجاجات إلى ربيع عربي في الجزائر بعد تونس، وفق نظرية الدومينو، وهو ما لم يتحقق لأسباب عدة سنتطرق لها لاحقاً.
ثم أدى سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الثاني 2011، إلى “فتح أبواب جهنم على الجزائر”، حسب أحد الوزراء الجزائريين؛ نظراً لأن الحدود الجزائريةـ الليبية (قرابة ألف كلم) أصبحت مفتوحة أمام جماعات تهريب السلاح، إلى درجة أن الجيش الجزائري ضبط صواريخ مضادة للطيران، ناهيك عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأدى وصول كميات كبيرة من هذه الأسلحة إلى جماعات انفصالية في شمال مالي (الطوارق والأزواد) وإلى جماعات إرهابية (مثل حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش فيما بعد) إلى سقوط شمال مالي في يد هذه الجماعات في 2012.
واختلال الأمن في دول مجاورة للجزائر مثل تونس وليبيا ومالي، جعل الجيش الجزائري ينشر عشرات الآلاف من جنوده على طول الحدود الشرقية والجنوبية، وكلف ذلك الجزائر ميزانية كبيرة لتأمين حدودها الملتهبة. ومع تراجع أسعار النفط في 2014، أصبحت ميزانية الدفاع تشكل عبئاً أكبر على الميزانية العامة للبلاد. ومع ذلك تعرضت الجزائر في 2013، إلى هجوم إرهابي عنيف على منشأة غازية في تيغنتورين، (جنوب شرق) انطلق فيه عناصر جماعة “الموقعون بالدماء”، التي أسسها مختار بلمختار المنشق عن القاعدة في 2013 (أسس جماعة المرابطون ثم اندرج مجددا مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، من شمال مالي وعبروا صحراء النيجر ودخلوا بسهولة إلى الجنوب الليبي ومنه هاجموا الأراضي الجزائرية، وقتلوا عشرات الرهائن الأجانب، قبل أن تتمكن قوات الجيش الجزائري من القضاء على جميع العناصر المهاجمة.
وعلى العموم، فالنظام الجزائري ينظر إلى ثورات الربيع العربي على أنها طوفان شعبي أسقط أنظمة صديقة أو حليفة أو على الأقل حارسة للحدود المشتركة مع الجزائر، وقد يصل هذا الطوفان إلى الجزائر، كما أن المستفيد الأول من الربيع العربي هو تيار الإسلام السياسي الذي أوصل الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر وتونس. ولكن الأخطر من ذلك أن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة استفادت من الربيع العربي خاصة من ناحية الاستيلاء على أسلحة نوعية، مكنتها من السيطرة على مدن في المنطقة مثل سرت في ليبيا، وغاو وتومبكتو وكيدال في مالي.
وبالنسبة لسوريا فالأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للنظام الجزائري عن الوضع في ليبيا، حيث ينظر إلى أن النظام السوري يقاتل تنظيمات إرهابية على غرار “داعش”. ويعتقد النظام الجزائري أنه في حالة سقوط نظام الأسد، ستتحول سوريا إلى غابة للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي ستتقاتل فيما بينها من أجل السلطة مثلما يحدث اليوم في ليبيا وأفغانستان. وهذا ما يجعل سوريا مهددة بالتقسيم وخلق دويلات على أساس عرقي أو طائفي.
ـ يوجد في سوريا نحو 100 إلى 200 جزائري ينشطون ضمن تنظيم داعش، وظهر في أحد أشرطة الفيديو، جزائريان من داعش يهددان النظام الجزائري بالقيام بعمليات إرهابية في البلاد. لذلك تخشى الجزائر عودة العناصر المسلحة في داعش من سوريا إلى ترابها لتهديد الأمن العام للبلاد، على غرار ما فعله “الأفغان الجزائريون”، حيث عادوا في بداية التسعينات من أفغانستان إلى الجزائر، وقاموا بتأطير الجماعات الإرهابية (الجماعة الإسلامية المسلحة)، وتدريب عناصرها خاصة بعدما اكتسبوا خبرة في القتال والتخطيط والتنظيم، وشاركوا في إغراق الجزائر في حرب أهلية، خلفت نحو 200 ألف قتيل، وأزيد من 20 مليار دولار خسائر مادية.
ولا تريد السلطات الجزائرية أن تتكرر نفس التجربة المريرة مع المقاتلين الجزائريين ضمن الجماعات الإرهابية في سوريا، لذلك يجد النظام الجزائري نفسه تلقائياً في معسكر النظام السوري بناء على مبدأ “عدو عدوي صديقي”.
ـ تنظر الحكومة الجزائرية إلى النظام السوري على أنه ضمن ما يسمى بـ”محور المقاومة”، حيث كان جزءاً من دول مجموعة “الصمود والتصدي”، التي تشكلت بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وتوقيع نظام الرئيس المصري أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع “إسرائيل” في 1978.
والنظام الجزائري يعتبر إسرائيل عدواً استراتيجياً، إذ أنه لم يوقع إلى اليوم اتفاقية سلام معها، وبالتالي فهو ينظر إلى نظام الأسد كحليف طبيعي في مواجهة العدو الصهيوني، رغم أن نظام الأسد لم يطلق أي رصاصة ضد إسرائيل منذ 1973.
ـ تشابه النظامان الجزائري والسوري، فكلاهما نظامان “قوميان”، وإلى وقت قريب كانا يتبنيان النظام الاشتراكي، كما أن النظام الجزائري لا ينسى أن سوريا كانت من بين أربع دول فقط لم تفرض التأشيرة على الجزائريين، عندما كانت بلادهم تعاني من أزمة أمنية سنوات التسعينات.
ـ روسيا بالنسبة للجزائر حليف استراتيجي فمعظم الأسلحة الجزائرية صناعة روسية، وبما أن موسكو منغمسة في الصراع السوري إلى جانب الأسد، فليس من الغريب أن تقف الجزائر مع المحور الروسي في مواجهة الغرب الذي يزعم دعمه للثورة السورية، والنظام الجزائري ورغم عدم مشاركته إلى جانب النظام السوري في القتال، فضلاً عن إيوائه نحو 25 ألف لاجئ سوري، من بينهم معارضين لنظام الأسد ينشطون بحرية في الجزائر (ينظمون مظاهرات أمام السفارة السورية بالجزائر، وندوات ومعارض وملتقيات بالتنسيق مع أحزاب وجمعيات جزائرية دون أن تمنعهم السلطات)، إلا أن عدم وقوف الجزائر ضمن الدول الداعمة لإسقاط الأسد يعتبر في حد ذاته دعما معنويا لهذا الأخير.
ـ النظام السوري من بين الدول التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والجزائر تعد من بين أكبر الدول العربية الداعمة لجبهة البوليساريو، مما يجعل نظام الأسد حليفا مهما للجزائر في هذا القضية، لذلك لا تريد الجزائر التفريط في هذا الحليف، الذي قد تخسره في حالة وصول نظام جديد إلى سوريا، على غرار ما حصل مع ليبيا، التي
كانت من بين 28 دولة وقعت على طلب عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وطرد الجمهورية العربية الصحراوية من الاتحاد بالرغم من أن ليبيا في زمن القذافي كانت أول دولة تعترف بالبوليساريو وأكبر داعم لها في فترة السبعينات، وبقيت داعمة لها سياسياً إلى غاية مقتل القذافي.
ـ استفزاز السعودية للجزائر بعد رفض الأخيرة الانضمام إلى التحالف العربي في اليمن، حيث أعلن السفير السعودي في المغرب أن بلاده ستقوم باستثمارات في الصحراء الغربية، مما اعتبر رسالة ضغط ضد الجزائر، التي ردت باستقبال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي تعتبر بلاده “عدو” بالنسبة للسعودية، ثم زيارة عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي إلى دمشق، وتم اعتبار ذلك رداً على الاستفزاز السعودي.
فموقف الرياض من القضية الصحراوية دفع الجزائر إلى اللعب بالورقة السورية بشكل علني، وتعزيز علاقات الجزائر مع النظام السوري بشكل أكبر، الذي تعاديه السعودية ودول الخليج، ورغم أن الرياض وعدد من العواصم الخليجية لجأوا في الأشهر الأخيرة إلى تهدئة الوضع مع الجزائر من خلال تبادل الزيارات على أعلى مستوى، ومحاولة ضخ مزيد من الاستثمارات في الجزائر إلا أن انسحاب دول خليجية من القمة الإفريقية العربية في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية احتجاجا على مشاركة الجمهورية الصحراوية شكل نقطة توتر جديدة في العلاقات الجزائرية الخليجية.
ـ بعض التسريبات تتحدث عن مساعي قامت بها الجزائر للتوسط (سراً) بين النظام السوري والمعارضة، على أساس المصالحة الوطنية، (على غرار الطريقة التي تم من خلالها حل الأزمة الجزائرية، والتي تتمثل في عزل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة عن المعارضة المسلحة، التي تقبل بوضع السلاح مقابل عفو شامل وتبييض صحيفة السوابق العدلية، مع تنظيم انتخابات تشارك فيها الأطراف التي ترفض استعمال السلاح للوصول إلى السلطة.
غير أن هذه المساعي لم تلق قبولاً لدى المعارضة السورية التي تشترط رحيل بشار الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي، وهو ما يرفضه النظام السوري بشكل مطلق، مما جعل الجزائر تتراجع عن لعب دور الوسيط وتقترب أكثر من موقف النظام السوري.
ـ من مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية التعامل مع الأنظمة بغض النظر عن طبيعتها (ديمقراطية أو تسلطية)، وبالتالي فهي تفضل التعامل مع النظام السوري الذي تعتبر أنه لازال يملك الشرعية، على أن تتعامل مع المعارضة التي ترى أنها غير موحدة ولا متجانسة سياسياً. أما عسكريا فهي منقسمة إلى عشرات الكتائب المسلحة المتناحرة فيما بينها، ومتعددة الولاءات للخارج، وتفتقد إلى قيادة عسكرية موحدة. وهذا ما يفسر اعتراض الجزائر على أن تشغل المعارضة السورية كرسي النظام الشاغر في الجامعة العربية، بحجة أن الأخيرة تضم الأنظمة وليس المنظمات أو الجماعات.
أزمة التسعينات منحت الجزائر “مناعة” ضد الربيع العربي
ـ الشعب الجزائري عاش حرباً أهلية رهيبة في فترة التسعينات من القرن الماضي، فقد فيها 200 ألف قتيل، ومئات الآلاف من الجرحى واليتامى، والنازحين (من القرى إلى المدن)، وجراح لم تندمل إلى اليوم، لذلك فهو لا يريد العودة مجدداً إلى تلك الأيام المأساوية حتى لو تخلى عن جزء من حريته لصالح الأمن، أو كما يقول المثل الجزائري “الهنا غلب الغنى” (الأمان غلب الرفاهية).
ـ الحكومة الجزائرية تملك من الأموال ما يمكنها شراء السلم الأهلي، حيث وفر ارتفاع أسعار النفط أموالا ضخمة في خزينة الدولة بلغت أزيد من 200 مليار دولار احتياطي صرف بالعملة الصعبة في 2014، ومداخيل سنوية تقدر بأزيد من 60 مليار دولار سنويا (78 مليار دولار في 2010)، وهذا ما ساعدها على تدعيم أسعار المواد الغذائية الأساسية وخفضها، ما أدى إلى امتصاص غضب المحتجين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كما قامت بتقديم منح للبطالين، وأطلقت مشاريع ضخمة للسكن مدعومة من الدولة (مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات).
ـ احتجاجات السكر والزيت ضمَّت في الغالب مراهقين، وبعض مناصري الفرق الرياضية، وكان عددهم بالعشرات في كل مدينة، ولم يحظوا بتضامن شعبي، خاصة بعد قيامهم بحرق محلات مواطنين، وسرقة ممتلكات شركات. كما أن الفئات المثقفة والسياسية لم تشارك في هذه الاحتجاجات في البداية لكنها حاولت استغلالها فيما بعد.
ـ أغلبية الأحزاب السياسية في الجزائر أصبحت عاجزة عن تحريك الشارع أو تنظيم حشود كبيرة كما كان الأمر في بداية التسعينات، حيث أصبح الشعب لا يثق في الأحزاب بمختلف توجهاتها، بل شهدت عدة انتخابات عزوفاً من الشعب عن صناديق الاقتراع؛ لعدم ثقته في الطبقة السياسية إجمالاً. وحتى عندما دعا سعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب أمازيغي علماني)، إلى تنظيم مظاهرات كل سبت فشل في جمع العشرات، ناهيك عن تنظيم ثورة، بل يعتبر أحد أسباب عزوف الشباب الغاضب على السلطة عن المشاركة في الاحتجاجات.
ـ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتمتع بنوع من القبول الشعبي خاصة لدى الطبقات الفقيرة والبسيطة باعتباره مهندس المصالحة الوطنية التي انتشلت البلاد من الحرب الأهلية، وخلال فترة حكمه تمكن من القيام بإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد من طرقات وشبكات مياه وغاز المدينة بفضل ارتفاع أسعار النفط، رغم ما رافق تلك المشاريع من إسراف وفساد.
الأوضاع في 2016 اختلفت عن 2011
بسبب تراجع أسعار النفط في 2014 من أكثر من 100 دولار للبرميل في 2013، إلى أقل من 30 دولار للبرميل في 2016، خسرت الجزائر أكثر من نصف مداخيلها من النفط، وبعد أن كان ميزانها التجاري يحقق فائدة بأكثر من 20 مليار دولار سنويا، بلغ العجز التجاري خلال 2016، أزيد من 17 مليار دولار، ناهيك عن تراجع احتياطي الصرف إلى 114 مليار دولار.
وتراجع مداخيل الدولة بالعملة الصعبة، أفقد الحكومة الجزائرية ورقة مهمة لضمان السلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار، خاصة أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار الغاز والكهرباء والسيارات، مع استمرار الدولة في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الطحين والسكر والحليب.
ورغم تذمر المواطنين من ارتفاع الأسعار إلا أن ذلك لم يصل إلى حد الخروج في احتجاجات كبيرة للمطالبة بإسقاط النظام، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية في السنوات العشر الأخيرة مقارنة بالتسعينات.
ونجاح الجزائر في إقناع الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها من تخفيض الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ساعد في ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً للبرميل، وأعطى ذلك جرعة أوكسجين إضافية للنظام الجزائري.
ورغم أن الحكومة لجأت إلى استدانة 900 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية في 2016، إلا أنها تعتبر من أقل دول العالم مديونية مقارنة بناتجها الإجمالي الخام، حيث تمكنت من تسديد مديونيتها، التي كانت 25 مليار دولار في عام 2000، بشكل شبه كامل. بل أقرضت البنك الدولي 5 مليار دولار في 2012، وأسقطت أزيد من 900 مليون دولار ديون مستحقة على 14 دولة إفريقية في مايو/أيار 2013 (البنين، بوركينا فاسو، الكونغو، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، موريتانيا، مالي، موزمبيق، النيجر، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، السيشل وتنزانيا) بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية 1963. (المصدر وكالة الأناضول)
لذلك مازال النظام الجزائري من ناحية المؤشرات الاقتصادية قادراً على مواجهة الأزمة الاقتصادية وشراء السلم الاجتماعي في 2017، إذا استمر تحسن أسعار النفط، وتقلصت فاتورة الاستيراد، وحتى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن يؤثر كثيراً على اقتصاد البلاد إذا لم يتجاوز 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، الذي قدر بـ220 مليار دولار في 2014، حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2015 (من بين أكبر خمس اقتصادات في الوطن العربي)، في حين أن معدل الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام في الجزائر، لا يتجاوز 8.7 بالمئة حسب منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وهو من أقل النسب في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وقبل الكويت التي حلت ثالثة، فمصر مثلا تمثل ديونها 87.7 بالمئة من ناتجها المحلي الخام.
لكن إن تراجعت أسعار النفط ما دون 50 دولار فسيكون عام 2017 صعباً، وقد يؤثر ذلك على الأوضاع الاجتماعية والسياسية على غرار احتجاجات 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي كان من أسبابها الأزمة الاقتصادية في 1986، التي انهارت فيها أسعار النفط الجزائري من 44 دولار إلى نحو 11 دولار للبرميل.
لكن في 2008 شهدت البلاد تراجعاً كبيراً لأسعار النفط متأثرة بالأزمة المالية العالمية، غير أن هذا لم يؤد إلى انهيار اقتصاد البلاد، ولا إلى ظهور احتجاجات عارمة تطالب بإسقاط النظام.
ـ الرئيس بوتفليقة الذي كان وجوده على رأس السلطة في 2011 أحد أسباب استمرار النظام بفضل خبرته في الحكم ونجاحه في تحقيق السِّلم وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أصبح مرضه اليوم يطرح أكثر من سؤال بشأن خلافته، ومدى إمكانية انتقال السلطة بشكل سلس ودون اضطرابات سياسية وأمنية، خاصة وأن 2017، سيشهد انتخابات برلمانية يستبعد أن تحدث مفاجآت كبيرة.
ـ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية كانت إحدى أيقونات الربيع العربي، وتم استعمال هذا الأسلوب في الجزائر لدى بعض الشباب الجزائري خاصة الإعلاميين منهم، ونجحت حركة “بركات” (كفى) الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، في حشد عشرات الأفراد في العاصمة الجزائرية في 2014، لكنها كانت حركة نخبوية، وأفرادها من مشارب مختلفة، وما يفرقهم أكثر مما يجمعهم؛ لذلك انطفأت شعلتها سريعا، خاصة وأن غالبية الشعب تبدي سلبية تجاه الحركات الاحتجاجية التي تسعى لإسقاط النظام.
بالنسبة للجماعات المسلحة الناشطة في الجزائر، نجد أن الجيش الجزائري تمكن من القضاء على تنظيم “جند الخلافة”، فرع داعش في الجزائر، في المهد حيث لم يقم هذا التنظيم بأي عملية كبيرة ضد البلاد منذ اختطافه الرهينة الفرنسية غوردال في 2013، حيث تم القضاء على أمير داعش الجزائر في نفس السنة مع معظم عناصر التنظيم، كما تم توجيه ضربة موجعة لجماعة صغيرة أعلنت ولاءها لداعش في جبال سكيكدة شرق الجزائر، لذلك فشل التنظيم حتى الآن في بناء كيان له في الجزائر.
أما التنظيم المسلح الذي يشكل أكبر تهديد إرهابي للجزائر فيتمثل في “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، بقيادة عبد المالك درودكال المدعوأبو مصعب عبد الودود ، ويتركز نشاطه في جبال سيدي علي بوناب في ولاية بومرداس (شمال وسط)، بالإضافة إلى نشاط محدود في مناطق جبلية في شرق وغرب الجزائر، لكن فرعه في الساحل الإفريقي يبدو أكثر نشاطا، ومنذ الهجوم على منشأة غازية في تيغنتورين بالجنوب الشرقي للجزائر في 2013، لم تشهد البلاد عملية إرهابية كبيرة، رغم محاولة جماعات مسلحة القيام بعمليات إرهابية في الجنوب الجزائري عبر الحدود مع مالي والنيجر وليبيا، لكن هذه الهجمات تصدى لها الجيش الجزائري، الذي أعلن في العديد من المرات اكتشاف مخابيء للأسلحة والذخيرة.
وعمليا تمكنت قوات الأمن الجزائرية، من عزل الجماعات الإٍرهابية في الجبال شمالاً، وتأمين المدن والبلدات، أما جنوباً فعززت تواجدها العسكري من خلال إرسال عشرات الآلاف من قواتها وبناء سياج أمني على الحدود مع ليبيا والمغرب، ومراقبة الحدود الجنوبية والشرقية والغربية بطائرات حربية وطائرات بدون طيار وبالأقمار الصناعية حيث أطلقت في 2016 ثلاث أقمار صناعية متعددة المهام.
وحسب لعمامرة فإن الجزائر هزمت الإرهاب استراتيجياً، وهذا الكلام قريب للواقع لأن الجماعات المسلحة في 1994، كادت تسقط الدولة، لكن منذ سنة 2000 انحسر بشكل كبير نشاط الجماعات المسلحة، لعدة أسباب من بينها:
ـ قضاء الجيش على 17 ألف عنصر مسلح منذ 1992 إلى غاية 2005، حسب وكالة الأناضول.
ـ الاقتتال بين الجماعات المسلحة فيما بينها قتل خلالها ثلاثة آلاف عنصر على الأقل، ما بين 1992 و1997.
ـ افتقاد الجماعات الإرهابية لحاضنة شعبية بسبب ارتكابها العديد من المجازر في حق مواطنين أبرياء وقرى مما أدى إلى تجند الشعب ضد هذه الجماعات سواء من خلال الدفاع الذاتي (تسليح المواطنين لمواجهة الإرهابيين في المناطق النائية)، أو عبر الحرس البلدي (ميليشيات محلية تصدت للجيش في القرى والبلدات النائية).
ـ أفتى العديد من شيوخ وعلماء التيار السلفي سواء في الجزائر أو في السعودية بحرمة الجهاد في الجزائر ما أدى إلى تسليم المئات منهم لأنفسهم، بالإضافة إلى المراجعات الفقهية التي قام بها بعض الأمراء الشرعيين للتنظيمات المسلحة، وأطلقت السلطات يد شيوخ السلفية العلمية الذين استطاعوا إقناع الكثير من “المتشددين” بحرمة الخروج على الحاكم، وأصبحت السلفية العلمية بديلا عن السلفية الجهادية التي استقطبت آلاف الشباب في التسعينات.
ـ سياسياً نجح قانون المصالحة الوطنية (2005) وقبله قانون الوئام المدني (2000) في تحييد الآلاف من المسلحين، الذين سلموا أنفسهم وأسلحتهم مقابل الاستفادة من العفو، ويتجلى هذا النجاح في أن عدد الجهاديين الجزائريين الذي يشاركون في القتال في الخارج، لم يتجاوز 200 عنصر، مقارنة بنحو 8 آلاف تونسي و1500 مغربي.
-داعش والقاعدة فشلتا أن يكون لهما موطئ قدم كبير في الجزائر بالنظر إلى أن الشعب سني ويحكمه نظام سني عكس سوريا والعراق اللتان تعانيان من تحشيد طائفي، لذلك فالاعتقاد أن الجزائر ستتحول إلى حلب، أمر يجانب الكثير من المعطيات الميدانية، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
لذلك يمكن القول فعلا أن الإرهاب في الجزائر فشل استراتيجياً، فبعد أن كان يقاتل لإسقاط النظام في التسعينات، تغيرت أهداف تنظيم القاعدة إلى محاولة إضعافه وإزعاجه، بعد أن فقد الحاضنة الشعبية له.
ورغم وجود عوامل ضاغطة على الحكومة إلا أنه لا توجد مؤشرات حقيقية توحي أن الجزائر ستشهد نفس مصير حلب السورية، مع أن عامل المفاجأة كان دوماً مطروحاً، فلا أحد كان يتصور أن نظام بن علي، سيسقط عندما أحرق البوعزيزي نفسه، وكذلك بالنسبة لأنظمة مبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح.
لذلك يمكن القول أن الحديث عن تحول الجزائر إلى حلب في ظل المعطيات الحالية أمر غير منطقي، ومبني على فهم غير واقعي للوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، ولطبيعة العقلية الجزائرية، التي تغيرت كثيراً مقارنة ببداية التسعينات، حيث أصبح الأمن أولوية بالنسبة للمواطن الجزائري خاصة أنه عاش فترة عصيبة لا يريد أي فرد العودة إليها، رغم عدم رضا فئات عديدة منه عن أداء النظام السياسي الجزائري على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية.
لتحميل التقرير من هنا