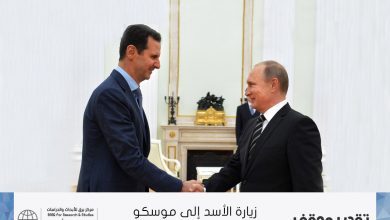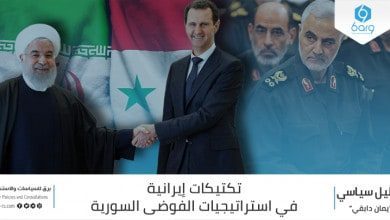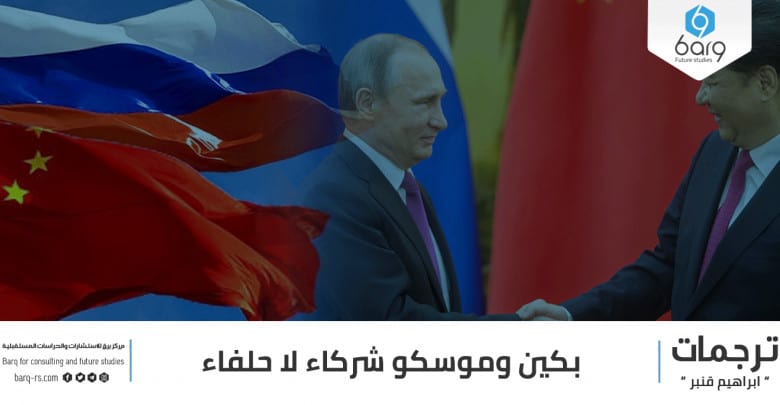
عندما التقى الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في السادس عشر من تموز/يوليو الفائت، كان الهدف من اللقاء تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكن ما حصل أن هذا السعي إلى تحسين العلاقات بين البلدين تحول إلى ارتباكٍ وغموض، الأمر الذي كان كافيًا بالنسبة لروسيا أن تميل أكثر من قبل إلى أحضان الصين، وذلك على الرغم من عدم توازن السلطة بين القوتين، إذًا يستمر الروس والصينيون في تعزيز علاقاتهما، كلاهما يدافع عن مصالحه الخاصة، وإن لم تتوافق هذه المصالح دائمًا.
يلاحظ المراقبون في الغرب بوضوح اختلالات توازن القوة بين روسيا والصين، ويعتقدون – سعداء – أن مثل هذه التضاربات يمكن أن تُعرّض العلاقات بين البلدين للخطر على المدى الطويل. ما يحصل على أرض الواقع هو أن قادة البلدين يتواصلون بشكل مستمر ويظهرون للعلن على الدوام قوة الشراكة والثقة المتبادلة بينهما.
منذ الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم والصراع في دونباس عام 2014، مرت العلاقات الثنائية، وفقًا لخبيرٍ روسي، في مرحلة “التفاهم” أي التعاطف والتنسيق المتبادل على أعلى المستويات السياسية، وعليه ازداد وصول الشركات الصينية إلى موارد الطاقة الروسية، واتضح هذا “التفاهم” عالي المستوى بتحسين وصول جيش التحرير الشعبي إلى التقنيات العسكريّة الروسيّة، بالإضافة إلى مزيدٍ من الفرص لاستخدام الأراضي الروسية من أجل مشاريع الطاقة التي تربط الصين بأوروبا.
في الواقع تمّ تجاوز عقبات مهمة، فالروس الذين كانوا يمتنعون سابقًا عن الموافقة على بيع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (s-400) للجيش الصيني، أعادوا النظر بهذا الإعراض ووافقوا على إكمال الصفقة، الأمر نفسه ينطبق على مقاتلات (Su-35). عداؤهم المشترك لنشر الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في آسيا دفع كلا الطرفين للانخراط في هذا المستوى من التعاون، وإن كان لا يزال حتى اليوم بحدودٍ متواضعةٍ فإن لهذا التشارك أهميةً رمزيّةً قويّة.
تم توقيع عقدٍ ضخمٍ في أيار/مايو عام 2014، الصفقة كانت تتعلق بخط أنابيب (قوة سيبيريا)، وفوق ذلك عوضت الموارد الماليّة الصينية عن الصعوبات التي كانت تعيق روسيا، بسبب العقوبات الغربية على موسكو، في تمويل مصنع (يامال) للغاز الطبيعي المسال، الآن تسيطر الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) على 20% من المشروع، ويساهم صندوق طريق الحرير أيضًا بنسبة تُقدّر ب 9.9%.
التوتر مستمر حتى التسعينات:
في مقابلة أجرتها مجموعة الصين للإعلام التي تُديرها الدولة في 6 تموز/يونيو 2018، قدّم الرئيس المنتخب من جديد فلاديمير بوتين نظرةً مريحةً ومتفائلةً حول علاقات بلاده مع الصين، حيث قارن شراكة بلاده مع بكين بمبنى “كل عامٍ يكتسب أبعادًا جديدة، طوابق جديدة، ترتفع أعلى وأعلى”، ثمّ أنّه وصف نظيره الصيني ب”الصديق الجيد والموثوق”، وفي نفس المقابلة تحدّث بوتين عن إمكانية التبادلات الناجحة كما وصفها في مجال الروبوتات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأيضّا رحّب بفعالية منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، هذه المجموعة تم إنشاؤها بجهود الدولتين معًا عام 2001، والتي تضم بالإضافة إلى روسيا والصين كازخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأزوبكستان، تعززت فكرة إنشاء هذه المجموعة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقلق موسكو وبكين على استقرار آسيا الوسطى، أصبحت مجموعة شنغهاي بالنسبة لبوتين منظمةً عالميةً بعد انضمام الهند وباكستان إليها عام 2017.
فيما يخص نظرة الشعب الروسي لعلاقات بلادهم مع بكين، هم أيضًا يميلون أكثر إلى الصين، وفقًا لاستطلاعٍ للرأي أجراه مركز (ليفادا) في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، رأى 2% فقط من الروس أن الصين تُشكل عدوًا لبلادهم، بينما رأى 67% من المُستطلع آراؤهم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأخطر على روسيا، 29% أشاروا إلى أوكرانيا و14% إلى أوروبا، وفي بحثٍ آخر أُجري في شباط/فبراير 2018 عبّر 70% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع عن وجهة نظرٍ إيجابيةٍ نحو الصين، مقابل 13% فقط كانت ردودهم سلبية.
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، حرصت السلطات الروسيّة والصينيّة معًا على التركيز على التنمية المحليّة، الأمر الذي كان يتطلب بيئةً دوليةً مواتية، كلا البلدين يريدان تجاوز ماضيهما الذي كان يتسم بالصراعات، ويطمحان إلى إرساء علاقاتٍ دائمةٍ ترتكز على حُسن الجوار.
في الواقع لم تكن سابقًا العلاقات الروسيّة الصينيّة على أحسن ما يُرام، فمنذ المعاهدات غير المتكافئة في القرن التاسع عشر، مرورًا بالتوترات الإيديولوجيّة بين القوتين الشيوعيتين في أواخر خمسينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى النزاعات المتكررة على الحدود المشتركة بينهما، والتي بلغت ذروتها عام 1969 في الصراع المسلح على نهر أورسوي (جزيرة دمانسكي بالنسبة للروس وجزيرة زن باو بالنسبة للصينيين).
في بداية التسعينات رأى باحثٌ صينيٌ أن التوتر الدائم له وزن ثقيل يُنهك الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لكل من الجانبين، لذلك كان من الضروري التخلص من هذه العوائق.
سمحت الرؤيةُ الموحدة للبلدين بشأن الحاجة إلى إقامة علاقاتٍ جيّدة بينهما للتوصل إلى اتفاقٍ بشأن ترسيم الحدود المشتركة، حدودٌ تمتدّ على طول أكثر من أربعة آلاف كيلومتر، استغرق الأمر وقتًا طويلًا، حيث لم يُكتب له النجاح بشكلٍ فعلي حتى عام 2005، حينها تمكّن الروس والصينيون من تجاوز العقبات الرئيسيّة التي كانت تقف في وجه تحسين العلاقات بينهما.
في موازاة استقرار الأوضاع وترسيم الحدود استقرت علاقاتهما العسكريّة والأمنيّة، بعد ذلك وفي عام 2009 تم تبني برنامجًا للتعاون لمدة عشر سنوات بين المناطق الحدوديّة للبلدين، تضمّن البرنامج 168 مشروعًا، كما تمّ إنشاء مجموعات عمل من الحكومتين للتعامل مع أي توترٍ محتمل، وللحدّ من تدفقات الهجرة غير القانونيّة، والإتجار غير القانوني بالسلع وحتى المشاكل التي تتعلق بالبيئة.
يُشار إلى وجود رغبةٍ حقيقيةٍ عند كل من موسكو وبكين في ترسيخ علاقاتهما الثنائية في جوٍ بنّاءٍ وسلمي، ما يُعزز هذه العلاقات هو التزاماتٌ متبادلةٌ بعدم تدخّل أي منهما في شؤون البلد الآخر، الصين وروسيا لا يثقان بوجود أطراف ثالثة بينهما قد يكون لديها مصالح في زعزعة استقرارهما، أو أبعد من ذلك، لا تخفي كل من موسكو وبكين أولويتهما في الحفاظ على نظاميهما.
الآن كلا الجانبين، وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، يعتبر أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عملت على دعم أو التنسيق لإحداث تغييرات في نظاميهما فيما يخدم المصالح السياسيّة والاقتصادية الغربيّة، وعلى أساس هذه الرؤية تم تفسير “الثورات الملونة” في الاتحاد السوفييتي سابقًا.
إذا كانت موسكو قلقة إزاء الثورتين الجورجيّة عام 2003 الأوكرانيّة عام 2004، فإن بكين قلقة أكثر بشأن ثورة الخزامى في قرغيزستان عام 2005 خشية امتداد آثارها إلى جيرانها، وخاصة تشجيع الشعور بالاستقلال في إقليم شينجيانغ ذو الأغلبية المسلمة.
كلاهما (روسيا والصين) يصرّان على جود “يد للغرب” في ثورات الربيع العربي، وكلاهما يتفقان ويزدادان تفاهمًا على ضرورة تعزيز الاستقرار على حدودهما، بالإضافة إلى أنهما يشعران معًا أنهما خاضعان لضغوطٍ لا تُحتمل بسبب الوجود العسكري الأمريكي في مناطق تثير تخوفهما، ناهيك عن دعم الولايات المتحدة لحلفاء وشركاء تعتبرهم موسكو وبكين خطرًا عليهما، كل ما سبق يُفسر لماذا لا يوجد (أو لم يعد يوجد) توتراتٌ قويةٌ بينهما في جوارهما المشترك في أجزاء من آسيا الوسطى.
تحرص بكين، ومع التطور السريع لوجودها الاقتصادي منذ عام 2000، على عدم وجود أي خلافٍ مع موسكو حول القيادة الأمنيّة والسياسيّة في هذا الجزء من حدودها، بالطبع هناك أساس تاريخي للتعاون بين الدولتين، فمنذ عام 1996 تمّ إنشاء منصّة متعددة الأطراف (مجموعة شنغهاي) كان هدفها ترسيم الحدود القديمة بين الصين والاتحاد السوفييتي السابق، ومواجهة حالات عدم الاستقرار في المنطقة.
لروسيا حدودٌ طويلةٌ جدًا مع آسيا الوسطى عبر كازخستان، والصين كذلك مع منطقة شينجيانغ في الشمال الغربي، لذلك بعد إنشاء مجموعة شينغهاي تحول التركيز على ما يسميه مسؤولو البلدين “خطر الإرهاب والتطرّف والانفصالية” وبالتأكيد يجد الروس والصينيون صعوبةً بالغةً في الاتفاق على تفاصيل هذه القضية.
منذ الحرب الشيشانية الثانية، شعر الروس “بخطر” مسلمي القوقاز، والصينيون أيضًا تخوفوا من “خطر” مسلمي شينجيانغ، وفي حين تَحفّظ المسؤولون الصينيون عن تأييد تصرفات موسكو في أوكرانيا، شدّدوا في الوقت نفسه على أنّ “الدبلوماسيون والقادة الصينيون يدركون تمامًا الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك الثورات الملونة المدعومة من الغرب في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، وكذلك هم على علمٍ بالضغوط التي تُمارس على موسكو من خلال توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق” هذا من ناحية الصين.
ماذا عن روسيا؟ من جانبها روسيا، وبينما تستمر في إظهار موقف الحياد بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، فإنها تدعم تحدّي بكين لدور الولايات المتحدة الأمريكية “المزعزع للاستقرار” في هذا الجزء من العالم، روسيا خرجت قليلًا كذلك من تحفظها التقليدي واتفقت عام 2016 على المشاركة في المناورات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي(بالطبع خارج المناطق المتنازع عليها).
في العام التالي عملت البحريتان معًا في بحر البلطيق، وهو أحد أكثر المناطق توترًا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في السنوات الماضية، إذًا البلَدان متعاونان بشكلٍ وثيق في القضايا الثنائية والدولية، مع ذلك وفي استعراض السنة الدبلوماسية 2016، ذكر المجلس الروسي للشؤون الدولية من بين توصيات عام 2018 أنّ هناك “عدم تماثل في العلاقات السياسية والاقتصادية مع بكين” واعتبر المجلس كذلك أنّ “أحد الأهداف الرئيسية التي يتعين على الدبلوماسية الروسية تحقيقها هو تحسينُ جودة هذه العلاقات”.
التعاون في الشرق الأقصى الروسي:
في كثيرٍ من المجالات كانت موازين القوّة بشكل واضح ضد روسيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، ولا سيما من الناحية الاقتصادية، وبما أنّ العلاقات جيدة بين القوتين فإن هذا الاختلال المتزايد لا يتم تحليله من قبل الروس من وجهة النظر الأمنيّة والسياديّة، المهم هنا أن العلاقات تحتفظ بكثير من جودتها، ومع ذلك لا يخفى على الروس أن هذا التفاوت في القوى مع الصين يهدد طموحات موسكو في تعزيز نفوذها.
على سبيل المثال، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي للصين يُشكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يُعادل 17.7% من الناتج الإجمالي العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهو عشرة أضعاف الناتج المحلي الروسي الذي يحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا ب 3.19% من الناتج الإجمالي العالمي.
وعليه فإن الصين بالنسبة لروسيا منذ عام 2010 أكبر شريك تجاري (15% من تجارتها الخارجية مع الصين)، مع ذلك تحتل روسيا المرتبة التاسعة فقط من بين شركاء الصين، ففي عام 2014 بلغت التجارة الصينية الروسية 95 مليار دولار(مقارنةً ب 16 مليار دولار عام 2003)، بينما يبلغ حجم التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي 615 مليار دولار، ومع الولايات المتحدة الأمريكية 555 مليار دولار.
في هذا السياق، يجب الإشارة إلى الإشكاليّة الموجودة في البنية التجاريّة بين روسيا والصين، فروسيا تُصدّر بشكلٍ أساسي المواد الخام وتستورد الأدوات والمعدات الصناعيّة، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت موسكو(على الرغم من اتفاقيات احترام الملكية الفكرية والتنافسيّة في أسواق السلاح) جعلها تقرر كسر عتبةٍ جديدةٍ في مبيعات الأسلحة (S-400 و Su-35 )، وذلك في محاولةٍ منها لتقليص المسافة التجارية بينها وبين الصين التي لا تزال استثماراتها تتفوق بكثير على الاستثمارات الروسية.
عدم التوازن هذا لا يتوقف فقط على استثمارات السلاح، إذ أن اختلالًا آخر يوجد في المنطقة الحدودية، هناك يعمل الروس جاهدون على إحكام قبضتهم على الوضع في الشرق الأقصى الروسي الذي يتعرض لعقبات من قبيل (انعدام التصنيع وهجرة السكان)، الجهد الروسي في هذه المنطقة يعود إلى خطورة الحالة فيها على الأمن القومي للبلاد، حيث تعتبر موسكو أن فشل برامج التنمية في أقصى الشرق سيُتيح لا محالة فقدان السيادة على هذا الجزء.
يرى الروس أنه إذا لم يُشكل ضعف برامج التنمية خطرًا على هذه المناطق الحدوديّة، فإنّ الخطر يبقى قائمًا بسبب التفاوتات الديمغرافيّة الكبيرة مع الصين (١.١ نسمة لكل كيلو متر مربع واحد في الجزء الروسي، مقابل 100 أو أكثر في مقاطعات شمال الصين). إضافةً إلى أنّ النشاط الاقتصادي الصيني، الذي تضاعف منذ التسعينات، يُعيد التوترات القديمة المرتبطة بوضع هذه الأراضي في التاريخ المشترك بين البلدين.
في نهاية القرن التاسع عشر، أدّى ضعف سيطرة الدولة الروسية على مناطق آمور وبريموري (مناطق في الشرق الأقصى الروسي) أدى إلى تشكّل جيوب في هذه المناطق تحت سيطرة النقابات العمالية الصينية، الأمر الذي جعل الكرملين يسعى جاهدًا إلى الحد من نشاط هذه النقابات.
وفي بداية التسعينات استثمر تجارٌ صينيون في أسواق الشرق الروسي، تميز هذا السوق بنقصٍ حادٍ بالسلع، استغل التجار الصينيون هذا النقص وقاموا بتصدير كمياتٍ كبيرةٍ من السلع الاستهلاكيّة، وبعد ذلك تم تنويع هذا التواجد، حيث لم يعد تجاريًا فقط، بل استثمر الصينيون أيضًا في أقصى الشرق الروسي بالزراعة والبناء وما إلى ذلك.
على أساس برنامج التعاون لعام 2009، سعت الحكومتان في السنوات الأخيرة إلى تحسين جودة العلاقات الاقتصاديّة بين مناطق شرق الصين والشرق الأقصى الروسي، ما يدفع الصين إلى مثل هذا السعي هو اهتمامها بتنمية منطقة الشرق الأقصى الروسي كسوق طبيعي للشمال الشرقي الصيني، أما الجانب الروسي لم يكن على استعدادٍ دائمًا لتنفيذ ذاك البرنامج بتأثير الافتقار إلى الموارد المالية، وكذلك بسبب البيروقراطية، بالإضافة إلى تناقض بعض السلطات على المستوى المحلي والاتحادي إزاء الوجود الاقتصادي الروسي في مناطق أقصى شرق روسيا.
من هذا كله تظهر محاولات موسكو للحفاظ على سيطرتها التنموية في هذه المناطق، فقد أنشأت عام 2012 وزارة التنمية في الشرق الأقصى، وقامت بإنشاء منصة فضائية (فوستوتشني)، وتحديث خط السكك الحديدية التي تربط بعض مناطق الشرق الأقصى الروسي(بايكا-آمور BAM)، والأهم من هذا كله هو عملها بشكلٍ فعلي على الحفاظ على توازن سياستها الخارجية تجاه آسيا.
بالتأكيد تخلّت موسكو عن فكرة أنّ تنمية الشرق الأقصى يتطلب استثماراتٍ أجنبية، لكن روسيا تفضل أن تكون مصادرها الاقتصادية متعددة، وبشكل مناقض أيضًا تعترف روسيا أنّ تطور الإقليم لن يكون سهلًا بدون العمالة الأجنبية.
تسعى روسيا أيضًا إلى احتواء التوسع الاقتصادي الروسي في آسيا الوسطى، فمثلًا وفي إطار مجموعة شنغهاي، رفضت موسكو (وكذلك كازخستان) إنشاء منصةٍ تجارةٍ حرّةٍ أو حتى بنك تنمية، ولاحتواء التوسع الصيني في مناطق آسيا الوسطى، قامت روسيا أيضًا بإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (الأوربي الآسيوي UEE)، في كانون الثاني/يناير عام 2015، وهي منظمة تكامل اقتصادي بين روسيا وأربع دول من الاتحاد السوفييتي السابق (أرمينيا وبيلاروسيا وكازخستان وقرغيزستان).
مع كل هذه الجهود الروسية بقيت مساحة مناورتها محدودة، لأنّ الدول سابقة الذكر لن تتردد أبدًا في توقيع اتفاقياتٍ ثنائيةٍ مع بكين، وخاصةً في مجال الطاقة والاستثمار، عندما ترى أنها تخدم مصالحها.
من المعروف أن النفوذ المالي الروسي ليس متفوقًا أبدًا على النفوذ الصيني، ومن الأدلة على ذلك أنّ (طرق الحرير) الجديدة ستؤدي إلى المزيد من القروض والائتمانان لدول آسيا الوسطى (التي تقترض بشكل طبيعي من البنوك الصينية التابعة للدولة وبشروطٍ قاسيةٍ في كثيرٍ من الأحيان).
بالإضافة إلى ذلك، بعد ضم شبه جزيرة القرم، أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أكثر حذرًا في علاقاتها مع روسيا، من هنا يبدو أنّ روسيا خسرت تصنيفها العاطفي عند هذه الدول التي كثيرًا ما كانت تفضّل روسيا إقليميًا ضد الصين، كان على تلك البلدان وغيرها أن تُدرك هذه الفكرة عن الصين: لا تخضع الاستثمارات الصينية أبدًا لاعتباراتٍ سياسيةٍ فيما يخص الصفقة الكبيرة بين موسكو وبكين، بل تعمل على أساس أهدافٍ اقتصاديةٍ عقلانية.
حتى روسيا تعرف تمامًا أنّ الديناميكية الصينية في آسيا الوسطى لا تتراجع بتأثير المخاوف السياسية (وهذا ينطبق أيضًا على القوقاز وأوكرانيا)، بأفضل الأحوال تمكنت روسيا من حفظ ماء وجهها ولو بطريقةٍ سطحيةٍ حتى اللحظة، بفضل الإعلان المشترك للرئيسين الصينين والروسي في أيار/مايو 2015، والذي بموجبه سيتم ربط كل من بنك التسويات الدولية (BRI) مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
الآن وبعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوراسي (ضوابط جمركية، والملكية الفكرية، والتعاون بين القطاعات، والمشتريات العامة، والتجارة الالكترونية، وضوابط المنافسة) بعد هذه السنوات سيكون لهذه الاتفاقية بالتأكيد المزيد من التأثيرات الملموسة على العلاقات بين موسكو وبكين.
يمكن القول أنّ الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية في عام 2018 قويّة جدًا، وذلك بسبب تعطّش الدولتين للاستقرار ورفضها المشترك لأي تدخل من الغرب، وخاصة من الولايات المتحدة، في دول الجوار الصيني الروسي، هذه الشراكة القويّة لا تعني بالضرورة التزام القوتين بالتنسيق المنتظم في القضايا الدوليّة الكبرى، ذلك على الرغم أن كلًا منهما يتجنب أي عملٍ من شأنه أن يعيق الآخر.
علاوةً على ذلك فإن الصين جزءٌ قويٌ من هذه الثنائية، فهي ترسم طريقها الخاص وتلعب بنقاطها الخاصة، بكين تنوي الاستثمار في روسيا فقط إذا كانت المشاريع مقنعة اقتصاديًا، وتبتعد عن انتقادات موسكو اللاذعة للغرب لما لها من مصالح اقتصاديّة مشتركة مهمة معه.
الأمر الآن متروكٌ لموسكو للتعامل مع الأسباب التي تعمق تباين القوّة أمام بكين، الأسباب التي إن تفاقمت ستؤدي إلى تآكل صورتها أو ربما المساس بأمنها القومي، حتى الآن روسيا راضيةٌ فيما يتعلق بتوجيه “الخطر الصيني” من خلال السعي لإقامة علاقة ثقةٍ لتقليل مصادر الاحتكاك، كما أنّ الحيوية العسكريّة والسياسيّة الروسية في الشرق الأدنى تعطيها المزيد من الثقة عند الحديث عن طريقةٍ ما لتوازن القوى.
مع أنّ ميزانية الدفاع في الصين لا تزال أعلى بكثير من ميزانية روسيا (150 مليار دولار في عام 2017، مقارنةً ب 45.6 مليار دولار لروسيا) إلا أنّ روسيا متقدمة على الصين في مجال الأسلحة النووية وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
تتوقع روسيا من الصين أن تلتزم بإرادتها في التغلب على التفاوتات الاقتصادية، وذلك من خلال التعاون الصناعي والمساهمات في تطوير البنية التحتية التي تفتقر إليها روسيا مقابل الصين.
لكن ليس من المؤكد أن ترى الصين الرغبة الروسية من نفس المنحى، إذ وفي الوقت الذي تحترم فيه بكين شريكتها، فهي لا تشعر أنها مضطرة إلى إيقاف تفوقها الاقتصادي، وبعد كل هذا تعود الكرة من جديد إلى ملعب روسيا، هل يمكنها أن تقود بلادها إلى تسريع تحديث الاقتصاد وتطويره؟ هل هي قادرة على اتباع نهج أكثر انفتاحًا في مجال العلاقات الدوليّة؟
ايزابيل فاكون: باحثة في مؤسسة البحث الاستراتيجي ((FRS
صحيفة لوموند ديبلوماتيك آب/أغسطس 2018
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/FACON/58982
“الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية “
جميع الحقوق محفوظة لدى مركز برق للاستشارات والدراسات المستقبلية © 2018